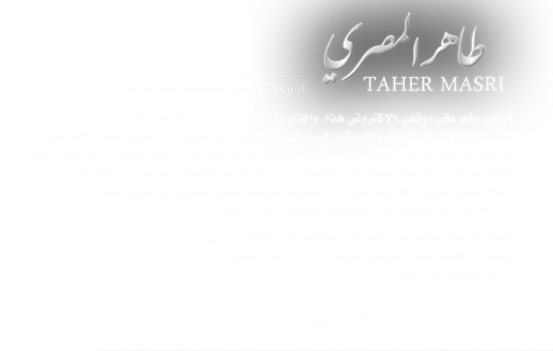

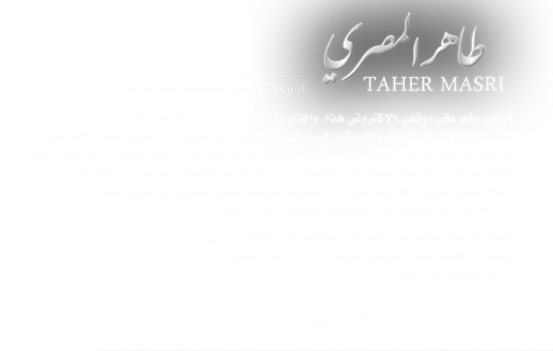

سياسي يتذكر الحلقة الخامسة عشر
5 ايار 2014
المصري: تحفظت على وادي عربة لانها لم تحقق ثوابتنا
محمد الرواشدة
عمان-لم يغادر رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري مرحلته في عضوية مجلس النواب الثاني عشر بعد، وما يزال يقلب صفحات ذكرياته السياسية في ذلك المجلس، مًُعلقا على مواقف الحكومات فيه.
ويكشف المصري اليوم في سلسلة حلقات "سياسي يتذكر"، تفاصيل الثوابت التي أقرتها حكومته خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، والتي حددت شروط حضور مؤتمر مدريد للسلام، والطلب من الدول المضيفة دعم هذه الشروط.
ويؤكد المصري على أن موقفه الرافض لقانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، الذي قدمته حكومة عبد السلام المجالي وأقره مجلس النواب الثاني عشر في إحدى جلساته بأغلبية 55 صوتا وحضور 79 نائبا وغياب نائب واحد، كان هو المصري، جاء لمخالفة مواد القانون لتلك الشروط والثوابت التي وضعتها حكومة المصري.
ويستزيد ابو نشأت في شرح الأسباب التي أدت إلى خروجه من سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب الثاني عشر، في دورته العادية الثانية، عندما استشعر برغبة مراكز القرار بإبعاده عن الصفوف الأمامية، وتحييد دوره في تلك المرحلة، وما تبعها من إجراءات التطبيع في العلاقة مع إسرائيل.
وكان المصري تحدث في حلقة الأمس عن محطة ترؤسه لمجلس النواب الثاني عشر (1993 - 1997)، في دورته الاولى، وذلك بعد ان تحدث في الحلقة الماضية عن استقالة حكومته ومرحلة قلقة من تاريخ الأردن السياسي الحديث مطلع التسعينيات.
وتفاصيل الحلقة فيما يلي:
كما جاء في القرار أن المفاوضات يجب أن تضمن عروبة القدس الشريف، وتؤكد على أنها جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملا بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقد كان الهدف وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء أن نسعى من تلك المشاركة إلى نتيجة أن يمارس الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير على ترابه الوطني، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة، والوقف الفوري للاستيطان تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، إلى جانب أن تسفر تلك المفاوضات التي جرت برعاية أميركية ودعم سوفياتي، عن تطبيق قرار 242 على كافة مراحل الحل، بما يضمن ترابطها وتحقيق الحل الشامل والسيادة الفلسطينية على الأرض والمصادر الطبيعية، والشؤون السياسية والاقتصادية.
ولقد سجل مجلس الوزراء ذلك القرار كسابقة، عندما أبلغ الأردن أصحاب الدعوة؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بأن شرط حضور الوفد الأردني الفلسطيني المشترك لمؤتمر مدريد للسلام معلق على قبول تلك المبادئ والثوابت ودعمها من أصحاب الدعوة.
- اتفاق أوسلو أعطى الأردن الحق بالبحث عن مسار تفاوضي مستقل عن الفلسطينيين، لكن من قال بأن تحملنا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه القضية الفلسطينية مرتبط بموقف منظمة التحرير؟
أولسنا الذين حذرنا من ضعف صمود منظمة التحرير في مواجهة استحقاقات دولية وقانونية، تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني؟ وعارضنا تفردها في تمثيل الشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط العام 1974.
نحن أخذنا ذلك الموقف من المنظمة ليس لاعتبارات شخصية، أو رغبة منا بأنانية أو تغول في تمثيل الشعب الفلسطيني، لكن حجتنا كان لها ارتباط بموقفنا القانوني من الدفاع عن الضفة الغربية والقدس العام 1967، في وجه الاحتلال، وأن هذه الصفة القانونية لا تتوفر للمنظمة، وتعب الراحل الحسين وهو يحاول إقناع العرب بذلك.
فأوسلو وغيرها من التصرفات الفلسطينية الأحادية، لا تعني بأي حال من الأحوال، التخلي عن ثوابتنا الوطنية والقومية، ويا ليت أن قانون المعاهدة تبنى تلك الثوابت في القانون، ولم يغفل أجزاء أساسية من قرار مجلس الوزراء الذي تحدثنا عنه.
• إذا، جلست على كراسي المعارضة البرلمانية، بعد موقفك من إقرار قانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية؟
-لا يمكن القول بذلك. أنا مأخذي دائما على التطرف في المعارضة، أو التطرف في الموافقة. قد يجد الإنسان منا نفسه رافضا لموقف رسمي معين، لكنه لا يكون رافضا لكل السياسات أو القرارات الرسمية.
كان لي رأي مختلف عن رأي حكومة عبدالسلام المجالي بمعاهدة السلام مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني بأني فتحت عليها النار، بعد أن وافق الأردن على مبدأ السلام، وتوقيع المعاهدة مع من كنا نعتبرهم أعداء.
وهذا كان موقفي في جميع المواقع التي أشغلتها، فأنت تعلم، كان لي مواقف في الحكومات التي شاركت فيها، وعارضت من داخل مجلس الوزراء قرارات بعينها، لكني لم أسجل نفسي في خانة المعارضة المطلقة لكل قضية وكل أمر. أعتقد بأني بذلك كنت متوازنا جدا بين مواقفي الوطنية من جهة، وبين تحملي أجزاء من المسؤولية الوطنية في المواقع التي كنت فيها من الجهة الأخرى.
لذلك، بقيت على مقاعد مجلس النواب، أمارس دوري التشريعي والرقابي كالمعتاد، ولم أُجر لمناكفة الحكومة أو رئيسها أو وزراء فيها. وإذا أردت أن تُسجل عليّ أي موقف معارض فقد عارضت بعض مواقف الحكومات، التي مرت على مجلس النواب الثاني عشر، وكنت أعارض أمام الراحل الحسين بعض قرارات الحكومة، ولم أكن أسعى للظهور الإعلامي في تلك المعارضة، لكسب الشعبية على حساب استقرار النظام السياسي، واستقرار أداء السلطات الدستورية، من خلال تعطيل أي من مسارات التشريعات في البرلمان، أو التأثير سلبيا في المزاج العام.
-قد تستغرب؛ ليس بسبب ما ذكرت، ولكن كانت عندي قناعة بأن مزاج مركز القرار، لم يعد يفضل وجودي، في أي من المقاعد الأمامية للمسؤولين.
وهو مزاج استطعت تفهمه تماما، جراء التعبئة الحكومية ضدي، سواء عند الراحل الحسين أو في مواقع رسمية أخرى. وأمام كل ذلك لم أكن أفضل أن انقلب على شخصيتي فحافظت على الهدوء ومارست شغبا سياسيا ناعما، عبر كتابة المقال الصحفي، الذي يتضمن رفضا جزئيا لمواقف رسمية في قضايا محددة.
أما عن قصة عدم رغبة النواب بترشحي رئيسا لمجلس النواب لدورة جديدة، فهذا ليس صحيحا، واستطيع القول بأن الموضوع كان مختلفا تماما، وأن ضغوطا نيابية كبيرة كانت تدعم ترشحي للموقع مرة ثانية، وذلك في إطار مشروعي، الذي نجحت به نسبيا، ودعمه زملاء نواب أفاضل، في تثبيت قوة مجلس النواب أمام الرأي العام، والتأكيد على استمرار أداء المجلس الحادي عشر من خلال المجلس الثاني عشر.
وفعلا، فقد التقى ما يزيد على 35 نائبا، يمثلون كافة الكتل والتوجهات السياسية، في مجلس النواب، واجتمعوا في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، واتخذوا قرارا بدعم ترشحي لرئاسة مجلس النواب في دورته الثانية، واتصلت بي توجان فيصل، ودعتني لحضور الاجتماع لمناقشة الأمر.
وهنا فقد تعرضت لضغوط نيابية شديدة في هذا السياق، وشفيعي كان في هذا الدعم النيابي التصدي بمسؤولية لحماية مجلس النواب والدفاع عن دوره الذي لعبه منذ بدء مسار التحول الديمقراطي العام 1989.
وبين من حضر ذلك الاجتماع عبد الله النسور، وقد كان موقفه واضحا من حكومة المجالي، وواضحا في دعم ترشحي، واقترح آلية لضمان التزام الجميع في التصويت معي، وكانت تلك الآلية هي أن توضع إشارة محددة، على أوراق المجموعة النيابية التي رشحتني، وكان مقترحه ذاك من أجل التأكد من تقيد الجميع بذلك والتزامهم.
كان الغائب الرئيسي عن ذلك الاجتماع هم أعضاء كتلتي، التي انتمي إليها، وانتدبت الكتلة فيما بعد صالح ارشيدات وعبد موسى النهار، لإعلامي بأن الكتلة قررت ترشيح سعد هايل السرور، وذلك بعد أن أعلنت عدم رغبتي في الترشح لمرة ثانية. حتى أن نواب فرادى زاروني في منزلي، وطلبوا مني الاستمرار بالترشح، وكان من ابرزهم النائب نواف القاضي، الذي طلب مني بإصرار أن لا اتخلى عن رئاسة المجلس بالرغم من الآلة الحكومية التي بدأت تتحرك باتجاه، لم يكن لصالحي.
-الأمر ليس له اتصال بحملي اللقب أو العكس، فبعد رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب تكون قد زهدت تماما بالمواقع والألقاب، وتكون المسؤولية استنزفت منك كل جهد وكل تعب.
صحيح أنني انتمي لجيل انخرط بالعمل السياسي، ولا يستطيع التوقف عنه، كما أن هذا النوع من العمل العام؛ العمل السياسي، هو قطاع لا سن للتقاعد فيه، ولا مجال لتغيير اهتماماتك عنه.
لكن ما جعلني ابتعد عن الاضواء، وأعتكف على دراسة المسار الاستراتيجي لمستقبل الدولة، معرفتي وإطلاعي على تفاصيل التحديات الداخلية والإقليمية، التي تعيشها المملكة، فقد خدمت في مواقع المسؤولية في ظروف صعبة، وعرفت معنى الصعوبات، التي واجهها الحسين رحمه الله، وأجهزة الدولة الأخرى.
لم يكن سهلا علي أن أتخلى عن طباعي في توضيح موقفي الوطني أمام أصحاب القرار، وليس أمام الشارع، الذي قد تأخذه الاصطفافات معي أو ضدي لخانة إذكاء روح الفتنة والتناقض.
علينا كسياسيين أن نعرف طبيعة مجتمعنا، وأن نكون صريحين مع انفسنا، فواقعنا مختلف، وتركيبة مجتمعنا مختلفة، لذلك على معارضتنا أن تكون مختلفة، وأسلوب دعمنا للنظام السياسي واستقرار الحكم مختلفة أيضا.
أنا إن كنت مقرا بواجب الالتزام بكل ما يصدر عن مركز القرار، وهو بالضرورة موقف وطني مسؤول، لكن إذا عارضت قرارا ما، أو سياسة ما، فإن ذلك قطعا يجب التعامل معه من باب الحرص والخشية من المساس بوطنك وشعبك وقيادتك. ولذلك يجب أن تكون صريحا في توضيح وجهة نظرك وموقفك، حتى لو كان ذلك على حساب إقصائك من الملعب السياسي أو تقريبك من مراكز القرار.
لا أريد أن أجعل الأمر شخصيا، لكن في الأردن أنت معارض فقط، عندما تمتلك وجهة نظر تخالف فيها وجهة نظر البطانة في مراكز القرار، فرأس الدولة دائما ينصف الجميع، لكن من يدخل المعلومات له ويشكل الانطباعات عن الشخصيات السياسية في الجلسات المغلقة، هم من يتحملون مسؤولية المواقف، التي تُتخذ من شخصيات سياسية، لها رأي مخالف أو مناقض لآرائهم.
نحن في الأردن عشنا مراحل سياسية، تعرفنا فيها على مدارس كثيرة في إدارة الدولة والإدارة العامة واستقراء السياسات المطلوبة والسياسات الممنوعة، ولدينا من الأمثلة من تلك الشخصيات الكثير الكثير، ليس أقلها ذلك الخلاف في مدارس الإدارة العامة بين الرئيسين المخضرمين زيد الرفاعي ومضر بدران، أطال الله في عمرهما، كما كان لنا قدرة على التعامل والاستفادة من مدارس ادارة حديثة في حكومات زيد بن شاكر وعبد الكريم الكباريتي، وبتواضع قد أكون أنا أيضا أنتمي لتلك المدارس الحديثة في وقتها.
وقبل هؤلاء جميعا، فلك في حقبة الستينيات والخمسينيات أن تكتشف بنفسك حجم التباين والفرق في أداء الحكومات ومواقفها من إدارة الدولة.
كل هذا كنا نعيشه وسط أجواء من الاستقرار المؤسسي، والرضا الشعبي النسبي، والحفاظ على هيبة الدولة، والتمسك بقيم الاحترام في لغة التخاطب بين كل هؤلاء الرجال المتناقضين الموزعين على مدارس الإدارة العامة، والمتناقضين حتى في الهوية السياسية والانتماء الفكري، وهو ما جعل الحسين يعظم منفعة الوطن عبر كل هذه التعددية.
لقد ظلت المسؤولية العامة واجبا مقدسا، ولم نكن نعرف غير أن العمل السياسي هو عمل وطني، يجب أن يكون خاليا من أي شخصنة، في السياسات، وأي انانية في القرارات، ولقد ساعدتنا كثيرا في هذا المجال حكمة الحسين، وقدرته العالية على الاستشراف والتنبؤ، وتركه مساحة كافية لمسؤوليه من أجل التصرف وإدارة الأمور، وفق أحكام القانون وبمرجعية دستورية، ممنوع العبث في تطبيقاتها.
ومضت علاقة ابو شاكر مع ذات المجلس بالتوتر، لكنها استمرت لنحو عام وشهر، أو ما يقرب ذلك، وتعرض، رحمه الله، لهجوم نيابي قاس من النائب توجان فيصل، في وقت لم يكن النواب الإسلاميون على علاقة جيدة مع حكومته، لكن ابو شاكر استطاع عبور عام جديد، من عمر مجلس النواب الثاني عشر، ممهدا الطريق لخليفته عبدالكريم الكباريتي، ليكون رئيسا للوزراء، وكانت تلك الفترة قد شهدت تحضيرا لتقديم أسماء رؤساء حكومات، من جيل الشباب، الذين تركوا انطباعا ايجابيا من خلال أدائهم في مجلس النواب، وقد يكون الكباريتي وابو الراغب وسعد هايل السرور من هؤلاء الشباب.
-لا أحد يستطيع التكهن بأسماء رؤساء الحكومات، في ذهن الراحل الحسين، أو ترتيب إعادتهم للحكومة أو ابتعادهم عن حظوظ العودة لمواقعهم. فهناك أسماء تتوقع وجودها في الحكومة باستمرار، وهي أسماء إن خرجت كنا نعرف بأنها ليست بعيدة عن ذهن الحسين، فهو على لقاء مستمر بها، لكنه، رحمه الله، كان يبعث بإشارات معينة، تستطيع من خلالها كعارف لطباع الحسين، وطريقة تفكيره، ان تخمن اين سيقع الخيار في الفترة المقبلة.
الإشارة التي كانت في اعتقادي واضحة، بأن الراحل الحسين، ومنذ لحظة تكليفي بتشكيل الحكومة، بدأ يفكر بأن الخطوة الأولى لدخول الأسماء على قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة هي خدمتهم في وزارة الخارجية، فالراحل الحسين، وكأنه يريد من ذلك أن يخضع المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة، في دورة عملية في السياسة الخارجية، واختبار قدراتهم على التقاط رسائله بسرعة، والتصرف بناء عليها، ببديهة عالية وحسن تصرف.
لذلك لمع نجم الكباريتي من خلال أدائه في مجلس النواب الثاني عشر، ومشاركته في الحكومات، التي تشكلت في المجلسين الحادي عشر والثاني عشر، وكان قد اقترب الكباريتي من الراحل الحسين في عدة مناسبات، واقترب أكثر منه بعد موقفه المتشدد والرافض لدخول حكومة عبدالسلام المجالي، في آخر تعديل عليها. ليأتي بعدها وزيرا للخارجية في حكومة ابو شاكر الثالثة، مواصلا مشواره نحو رئاسة الحكومة خليفة لأبي شاكر.
-لقد قدم الكباريتي حينها مقترحين لطريقة تشكيل حكومته، الأول كان يتضمن قائمة أسماء لوزراء من خارج مجلس النواب، ووزرائها المُفترضين بعيدين عن المجلس، والقائمة الثانية كانت تضم أسماء الوزراء من أعضاء مجلس النواب، ليتم اختيار القائمة الثانية، ودخول هذا العدد الكبير من النواب في حكومته، وهم كما قلت 22 نائبا وزيرا.
صحيح أن هذه الطريقة في تشكيل الحكومة كانت ذكاء منه، لتقليل هوامش الشغب النيابي ضد حكومته، ودعم التصويت على كل مشاريع القوانين، التي تبعث بها الحكومة، بالإضافة إلى نجاحه في سحب بعض العناصر النيابية من جبهة المعارضة البرلمانية، التي كانت جبهة ليس سهلا مواجهتها.
لكن من مأمنه يؤتى الحذر، فلو ترك الكباريتي جبهة المعارضة النيابية فاعلة، ولها تأثيرها على سياسات وقرارات الحكومة، لاستطاعت تلك المعارضة "فرملة" قراراته، التي كانت سببا رئيسيا بإقالة حكومته، وتحديدا قرار الخبز، الذي كان للجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمير الحباشنة، في مجلس النواب، رأيا متقدما في تقليل رقم الرفع، لكن الكباريتي نجح وعبر وزرائه النواب في أن يخالف قرار اللجنة، وهو ما تسبب بالغضبة الشعبية الشهيرة العام 1996، وكانت واحدة مع جملة أسباب أخرى، أدت إلى إقالة حكومة الكباريتي.
لكنها تجربة جديدة، من تجارب الحكومات البرلمانية، ولا شك بأننا استفدنا منها لاحقا في تقييم أداء الحكومات النيابية، التي تتشكل بعيدا عن الموقف السياسي المشترك، والبرنامج التنفيذي المُتوافق عليه بين أعضائها. فما أريد قوله بأن الحكومات النيابية بالضرورة يجب أن تكون حكومات حزبية أو حكومة ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب، وهذه هي خريطة طريق الإصلاح، التي يجب أن تبدأ بتغيير ثقافة الناخب، واستعادة ثقته بدور الأحزاب، برامج ودورا وحضورا، ثم قانون الانتخاب، الذي عليه هو الآخر، أن يساعد طرفي المعادلة الانتخابية، الناخب والمرشح، في الدخول لمجلس النواب على أرضية من الثقة والثبات، وبعد ذلك لك أن تغير طريقة تشكيل الحكومات، وتترك للمجلس حرية التوافق بين كتله الحزبية على الرئيس والأعضاء والبرامج والأفكار. باختصار هذا هو الإصلاح السياسي البرلماني الذي نحتاج ونريد.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved